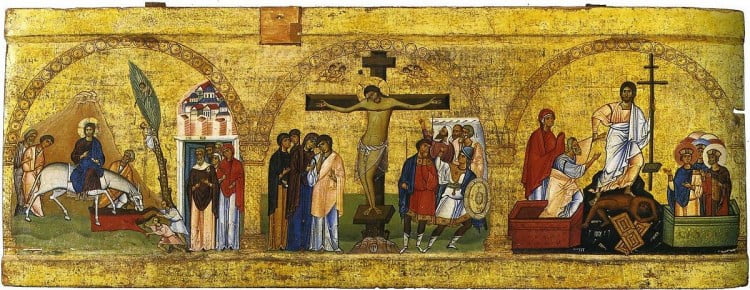"خدم الأسبوع العظيم التي نبيع كلّ شيء، لنشتريها"
(جورج خضر، أنطاكية تتجدّد، صفحة 107)
أقدم صوم يسبق عيد الفصح هو صوم الأيّام الثلاثة الأخيرة. ويبدو، كما هو مقبول عمومًا، أنّ هذا الصوم، الذي ما زال بعض المؤمنين يمارسونه إلى اليوم بانقطاعهم كلّيًّا عن الطعام، هو الذي امتدّ إلى أسبوع كامل، هو الأسبوع العظيم المقدّس، قبل أن يُلحق به، في مطلع القرن الرابع، الصوم الأربعينيّ المقدّس.
لن نستطرد في أسباب تطوّر الصوم الأربعينيّ. فما يعنينا، الآن، هو ترتيب خدم أسبوعه العظيم. وهذا، كما يبدو ظاهرًا، تحملنا مواضيعه العامّة إلى عيد الفصح، وتزوّدنا، في آنٍ، ما يجعله حيًّا فينا دائمًا.
أوّل وقفات هذا الأسبوع هو تعييدنا، يوم الإثنين العظيم، لـ"يوسف المغبوط الكلّيّ الحسن". أهمّيّة يوسف أنّه، آبائيًّا، صورة للمسيح المغرَّب حسدًا والمتألِّم والمحيي (اقرأ عنه في كتاب التكوين: 37- 50). ولكنّ هدف ذكراه هنا، في أبعاد تتقاطع مع تشبيه الآباء، أنّه كان مخلصًا لله في أرض غربة. فيوسف أبى، في أرض مصر، أن يدنّس نفسه مع امرأة فوطيفار، خصيّ فرعون ورئيس حرسه، "التي طمحت عينها إليه" (39: 7). وهذا الإخلاص، الذي هو سبيلنا إلى عيد الفصح، هو ما يعبّد لنا درب حياتنا بعد حلوله. فكيف نقدر على دوام الإخلاص، فيما نخرج إلى العالم، بعد انتهاء أيّام الصوم التي كانت لنا إقامة في أرض الله؟ ذاك هو السؤال الذي يطرحه علينا هذا التعييد. فالعالم أرض غربة. وقد يأخذنا بريقه الخدّاع بعد حلول الفصح. ولذلك يدعونا يوسف، في أوّل أيّام هذا الأسبوع، إلى أن نحذو حذوه، لنعيّد الفصح، ونبقى، مخلصين، مقيمين فيه.
يرافق التعييد ليوسف ذكرى "التينة التي لعنها يسوع، فيبست". وهذا، إلى جانب مثل "العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات"، الذي نذكره يوم الثلاثاء العظيم، يقيمنا أمام موضوعين كتابيّين (متّى 21: 18- 22، 25: 1- 13). وفي إحساسي أنّ اختيار الكنيسة، في اليومين الأوّلين، مواضيع كتابيّة (مع التعييد الكتابيّ ليوسف ضمنًا)، ليس اختيارًا عابرًا. صحيح أنّ التينة، كما تقدّمها خدمة اليوم الأوّل، رمز لـ"محفل الأمّة العبرانيّة التي غدت خاليةً بالكلّيّة من الأثمار الروحيّة". وفي الواقع، هذا، كتابيًّا، هو معناها الأساس. ولكنّ الصحيح، أيضًا، أنّها رمز لنا، نحن أيضًا، إن لم نثمر فصحيًّا، أي إن لم نُبقِ مصابيحنا مشتعلة دائمًا، ونسهر بانتظار "الختن" (العريس) الذي بزغ من القبر، في اليوم الثالث، "ساطعًا كالبرق". هل هذا كلّ شيء؟ لا، بل ينقصنا بعدُ أن نعرف من أين نأتي بالزيت الذي يبقينا، "ساهرين"، قائمين في النور. وهذا، عندي، واحد من أهمّ الأسباب التي دفعت كنيستنا إلى اختيار هذه الروايات الكتابيّة في أيّام الأسبوع العظيم الأولى. فكلمة الله، التي هي "سراج أرجلنا ونور سبيلنا" (مزمور 118: 105 و133)، هي التي تعلّمنا، مطيعين، كيف نثمر. ليس غريبًا عن الكنيسة أن تعلّي كلمة الله، وترفع المؤمنين إلى حبّها وقراءتها وطاعتها دائمًا (كما دوّى صوتها في مسرى الصوم الأربعيّني كلّه). فالتعييد للفصح يفقد رونقه إن لم يزد اقتناعنا بأنّ الكلمة هي حصننا المتين، لنبقى فصحيّين. هذا الذكر المزدوج ليوسف وللتينة، والعبرة التي نستشفّها من "مثل العذارى العشر"، إنّما كانا لنعرف أنّ الإخلاص لله، في أرض الغربة (العالم)، قاعدته حفظ كلمة الله (لوقا 2: 19) التي هي قوّتنا وخلاصنا (رومية 1: 16).
أمّا اليوم الثالث، أي يوم الأربعاء المقدّس، فنقيم فيه ذكرى "المرأة الزانية التي دهنت الربّ بطيب" (متّى 26: 6- 16). ثمّة خلاف بين المفسّرين حول هويّة هذه المرأة. سنترك، هنا، هذا البحث جانبًا. ونحاول أن ندخل، قليلاً، في معنى العيد. ما يجب أن نلاحظه، أوّلاً، أنّ هذه الذكرى كتابيّة أيضًا. وإذا دقّقنا في النصّ، لندرك السبب الوجيه الذي دفع الكنيسة إلى إعلاء هذه المرأة في هذا اليوم، فلا تخفى علينا العبرة. فهذه المرأة أهمّيّتها القصوى أنّها لم تعقها خطاياها عن اقتحام المكان الذي كان فيه الربّ يسوع، وأنّها لم تكتفِ بدهنه بطيب، بل أقامت عند قدميه، كما يبيّن تقبيل القدمين في الأنشودة الرائعة المنسوبة إلى القدّيسة كسياني (قابل مع: لوقا 7: 38). وباعتقادي أنّ هذه الإقامة هي ما تريدنا الكنيسة أن نحفظها في طريقنا إلى الفصح، وأن نحفظ أنفسنا، بعد حلوله، بها. وهل غير هذا معنى التوبة؟ المرأة عبّرت عن حبّها للحياة الجديدة هكذا، لتوحي إلينا بأنّ التوبة ليست أن نقرّ بذنوبنا فحسب، بل أن نستتبع هذا الإقرار بقبول الموقع الذي يحمينا، ويحيينا، أي أن نجلس، ما حيينا، عند قدمي يسوع (لوقا 10: 39). ولا يفوتنا أنّ الربّ، في تعليقه على تصرّف المرأة، عبّر عن أنّه يريد لنا ما فعلته قبل أيّ أمر آخر، بقوله: "أمّا الفقراء، فهم عندكم دائمًا أبدًا. وأمّا أنا، فلست عندكم دائمًا أبدًا". من يعرف "فكر المسيح"، لا يمكن أن يعتبر أنّ هذا القول يتضمّن إنكارًا لعون مساكين الأرض. فالسيّد، هنا، لا يفاضل بين محبّتنا له ومحبّتنا لفقراء الأرض الذين وحّد ذاته بهم (متّى 25: 40). لكنّه يوحي بأنّ معونة المساكين منطلقها محبّته، أو، كما تبيّن المناسبة، الإقامة عند قدميه. فكلّ من ينحني لـ"محبّة السيّد المجنونة"، هو، في الواقع، المؤهّل لأن ينحني أمام أقدام فقراء الأرض. لأنّه، هناك فقط (أي عند قدمي يسوع)، يدرك المقيمون على حبّه أنّ قدميه الطاهرتين هما عينهما أقدام الفقراء، فيصرفون حياتهم بغسلها بطيب لا يمكن أن يضيع ثمنه في عيني الله.
في المساء عينه، تدعونا الكنيسة المقدّسة إلى أن نقيم "سرّ الزيت المقدّس". هذا السرّ، الذي يوصي القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم بإقامته للمرضى دائمًا، هو، باختصار شديد، معنًى من معاني سرّ التوبة (من دون أن نفهم أنّه يحلّ محلّ سرّ التوبة والاعتراف). إذ إنّه يعلّمنا، بفصاحة مذهلة، أنّ المهمّ، فيما نطلب الشفاء من أمراضنا، أن نسعى إلى شفاء قلوبنا أوّلاً. سبع رسائل وسبعة أناجيل وسبعة أفاشين تحوط بها صلوات يفوق غنى تعابيرها الوصف. كلّها تبحث، من جوانب متعدّدة، شأنًا واحدًا. الأناجيل تحكي، ولا سيّما عن قدرة يسوع على الشفاء (لوقا 10: 25- 37؛ لوقا 19: 1- 10؛ متّى 10: 1، 5- 8؛ متّى 8: 14- 23؛ متّى 25: 1- 13؛ متّى 15: 21- 28)، وتُختم بدعوة متّى وقبول يسوع ضيافته على "مائدة الخطأة" (متّى 9: 9- 13). والأفاشين تقيمنا أمام السيّد الشافي والتائب علينا إذا ما تبنا إليه. وأمّا الرسائل التي تُفتتح بمقطع من رسالة يعقوب المسجِّل وصيّةَ إقامة السرّ (5: 10- 16)، فتدور كلّها على موضوع حياة الجماعة الكنسيّة (رومية 15: 1- 7؛ 1كورنثوس 12: 27- 30، 13: 1-8؛ 2كورنثوس 6: 16- 18، 7: 1؛ 2كورنثوس 1: 8- 11؛ غلاطية 5: 22- 26، 6: 1 و2؛ 1تسالونيكي 5: 14- 23). وبهذا كلّه يتصوّر الشأن الواحد أمامنا. فقبل العيد، دعوتنا الواجبة أن نقتنع بأنّ التوبة، التي هي شفاؤنا الكامل وسبيلنا إلى الفصح، لا يمكن إتمامها، حقًّا، من دون قبول الاندماج في حياة الجماعة. دعوة متّى الختاميّة هي، في هذا السرّ، دعوتنا الشخصيّة، أي دعوتنا أن نحيا مع الربّ كـ"خطأة تائبين"، وأن نقبله في بيوتنا سيّدًا على حياتنا وحياة مَنْ لنا وإلينا. وما يعمّق فينا حبّ التوبة، ويجعلنا فصحيّين دائمًا، أي معتقين من كلّ مرض، هو التزام الحياة الكنسيّة بكلّ تفصيلها وتفاصيلها.
في يوم الخميس العظيم، نعيّد لمواضيع عديدة "تقلّدها آباؤنا القدّيسون من الرسل الإلهيّين"، وهي: "الغسل الشريف والعشاء السرّيّ (أي "تسليم الأسرار الرهيبة لنا") والصلاة الباهرة العجيبة وتسليم ربّنا من يهوذا إلى أمّة اليهود". أوّل ملاحظة يجدر بنا ذكرها، هو أنّ حلول خدمة سرّ الزيت محلّ صلاة سحرّية هذا اليوم قد خفّف، نسبيًّا، التركيز على بعض هذه العناوين. صحيح أنّنا نسمع عن الغسل، الذي لا تتمّ ممارسته اليوم إلاّ نادرًا، في قراءة الإنجيل وبعض قطع الخدمة، وأنّ خيانة يهوذا يبقى، في بعض الصلوات، ذكرها ملحًّا، وأنّ صلاة يسوع الكهنوتيّة نسترجعها مساء. ولكنّ الصحيح، أيضًا، أنّ الموضوع المسيطر على إيقاع الخدمة هو "العشاء"، أو أنّه هو محورها جميعًا. وهذا، هنا، ما سنتوقّف عنده قليلاً. من المفيد أن نذكر أنّ الربّ، الذي سنراه في مساء اليوم ذاته "معلّقًا على خشبة"، هو "حمل الله" الذي يقدّم جسده ودمه "من أجل حياة العالم". ومعلوم أنّ السبب الرئيس لإقامة هذه الخدمة الإلهيّة، في هذا اليوم العظيم، هو أنّ السيّد جمع تلاميذه في علّيّة صهيون، وأسّسها في اليوم ذاته. ولكنّ لهذه الإقامة معانيَ أخرى تفترضها "الذكرى". ففي الواقع، إذا استثنينا يوم الجمعة العظيم، تجمعنا الكنيسة، في كلّ أيّام هذا الأسبوع، حول "مائدة الربّ". هذا التركيز على "العشاء" هو ما يجب ألاّ يفوتنا في طريقنا إلى الفصح، ولا في حياتنا كلّها. فالربّ، الذي مات وقام، يكوّننا في كلّ خدمة إلهيّة، أي يجعلنا "شعبه وميراثه". المعنى الرئيس، الذي تريدنا الكنيسة أن ننتبه له، هو أنّ حياتنا المسيحيّة، بما تفترضه من جهاد موصول، هي، في واقعها ومداها، مستحيلة بعيدًا من "عشاء الله". الفصح آتٍ. ولكن ما يجعل الفصح باقيًا فينا، هو التفافنا حول مائدة الربّ في كلّ أحد وعيد. كلّ مائدة إلهيّة هي مائدة فصحيّة. بمعنى أنّ من يعيّد للفصح يختار مائدة الربّ دفعًا إلى فصح دائم له ولجماعته. وتبقى المائدة، في واقعها الممدود، تحثّنا على أن نخلص لله. فـ"لا نعطيه قبلة غاشّة مثل يهوذا". ونحيا من مظاهر تواضع يسوع الذي يريدنا أن نحذو حذوه في صلاته الباهرة وغسله أرجل تلاميذه.
خدم الأيّام الثلاثة العظيمة المتبقّية (الجمعة، السبت والأحد) كانت، قديمًا، تقام في يوم واحد، أي تمثّل "سهرانيّة الفصح" التي كانت تجري فيها معموديّة الموعوظين (ومصالحة التائبين). لا يمكننا تعييد الفصح من دون الوعي أنّ العيد هو "مشاركة في موت المسيح وقيامته". وهذا، تحديدًا، هو معنى المعموديّة (رومية 6: 3- 11)، وتاليًا معنى عيد الفصح الذي نرتّل فيه للمسيح الذي "وطئ الموت بالموت"، أي موته وموتنا جميعًا. إذا راجعنا التاريخ القديم، نقف على أمر أساس، وهو أنّ المعموديّة، التي كانت تجري في قاعة خاصّة خارج الكنيسة، هي التي كانت تُدخل المعمّدين الجدد حياةَ الكنيسة المنتصرة. وهذا، الذي تمثّله خدمة "الهجمة" اليوم، هو أوّل ما يجب ألاّ يفوتنا في الفصح. لقد كان الصوم مناسبة لنا، لنعي أنّنا معمّدون، أي، بكلام دقيق، أنّنا لله ولكنيسته. وعليه، فإنّ ما تقوله بعض الشيع "المتجدّدة"، التي تطلب تجديد من ينتمي إليها، لا قيمة له عندنا. لا بل إنّ كلّ معمّد يقبله يعتبر، برأي الكنيسة، خارجًا عنها وعليها. من يعِ أنّ كنيسته رتّبت له أن يجدّد ولاءه لمعموديّته في الفصح، وفي كلّ خدمة إلهيّة، وفي كلّ لحظة من لحظات حياته، لا يمكنه أن يرتضي ترتيبًا غريبًا. فالكنيسة الأرثوذكسيّة كنيسة كاملة. إذ لا شيء ينقص المعمّد، ليطلبه خارجها. الولاء للمعموديّة، أو تجديدها، هو، بالضبط، ولاء للكنيسة الأرثوذكسيّة التي تجمعنا حول المسيح الحيّ، والتي تقدّم لنا حياته في كلّ "اجتماع" تقيمه.
قبل الفصح، كانت لنا هذه المعاني المبرورة، لنلتزمها في دربنا إلى الفصح العظيم، ونبقى بها فصحيّين دائمًا، أي "أحياء قاموا من بين الأموات" (رومية 6: 13).